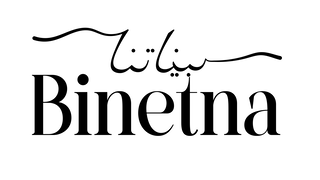لقد خطت تونس خطوة تشريعية كبرى باعتمادها، في أوت 2017، القانون عدد 2017-58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
وقد شكّل هذا القانون منعطفًا مهمًا في الاعتراف المؤسسي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
في الواقع، يعترف النص رسميًا بأشكال متعدّدة من العنف، سواء كانت جسدية أو نفسية أو اقتصادية أو سياسية.
كما ينصّ على إجراءات للوقاية، وحماية الضحايا، وآليات لمعاقبة الجناة.
يمثّل هذا القانون تقدّمًا كبيرًا يضع تونس ضمن الدول التي حدّثت إطارها القانوني في مجال حقوق النساء، وفقًا لـ Women’s Learning Partnership.
ومع ذلك، وبعد خمس سنوات من اعتماده، يبرز واقع مقلق.
فالفجوة بين الإطار القانوني الذي وضعه القانون والواقع اليومي الذي تعيشه العديد من النساء ما تزال مثيرة للقلق.
فقد أشارت عدة تقارير مستقلة إلى أن تطبيق القانون يصطدم بضعف بنيوي مستمر.
وتتعلق هذه الاختلالات خصوصًا بالإجراءات الأمنية، ومعالجة الشكاوى قضائيًا، ونقص خدمات المرافقة.
وبالتالي، تبقى العديد من النساء عرضة للخطر، ويتخلى جزء كبير منهن عن تقديم الشكاوى.
حقوق مُعترَف بها على الورق، لكن نادرًا ما تُطبَّق
على الصعيد القانوني، يضع القانون 2017-58 التزامات واضحة.
فهو ينصّ خصوصًا على إحداث وحدات متخصصة، واعتماد إجراءات استعجالية، وآليات لحماية الضحايا.
غير أنّ التنفيذ الفعلي لهذه الأحكام ما يزال محدودًا إلى حدٍّ كبير.
إذ تبقى الوحدات المتخصصة الفاعلة فعليًا قليلة.
كما أن التكوين المستمر لقوات الأمن والقضاة محدود.
ويُضاف إلى ذلك نقص التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
من جهة أخرى، يشير العديد من المراقبين إلى بطء إداري متكرر، وإلى رفض تسجيل الشكاوى، إضافة إلى ممارسات تمييزية متواصلة، خاصة على المستوى المحلي.
إستمرار المعايير الاجتماعية والوصم
إلى جانب الإخفاقات المؤسسية، تواصل المعايير الاجتماعية إعاقة التطبيق الفعلي للقانون.
وتُظهر استطلاعات الرأي والدراسات الوطنية أنّ العنف ما يزال يُنظر إليه على نطاق واسع كمسألة خاصة.
وبالتالي، تتردد العديد من الناجيات في التبليغ عن الاعتداءات.
ويُفسَّر هذا التردد بالخوف من الرفض الاجتماعي، أو الوصم، أو الانتقام.
كما تستمر النظرة السائدة في اعتبار العنف داخل الأسرة مشكلة منزلية، لا جريمة يُعاقب عليها القانون.
ووفقًا لاستطلاعات حديثة أجراها Afrobarometer، فقد تعرّضت نسبة مهمة من النساء في تونس، خلال حياتهن، لأشكال من العنف الجسدي أو الجنسي.
مناطق غموض قانوني وتفسيرات متباينة
تتمثل مشكلة كبيرة أخرى في مناطق الغموض القانوني التي يتضمنها القانون.
فالنص ليس واضحًا دائمًا، كما يختلف تطبيقه من منطقة إلى أخرى.
وبذلك، قد يفسر بعض القضاة المادة نفسها بطريقة مختلفة، خصوصًا فيما يتعلق بالعنف الزوجي.
وفي الواقع، قد يُحكم على وضع مماثل بشدة في محكمة ما، وبقدر أكبر من التساهل في محكمة أخرى.
وفوق ذلك، يبقى القانون غير دقيق بخصوص بعض العقوبات أو التدابير الواجب اتخاذها.
ويمنع هذا الغموض القانوني في كثير من الأحيان السلطات من اتخاذ إجراءات سريعة ومتناسقة.
وفي بعض الحالات، يؤدي هذا الغموض إلى تفسيرات تقلّل من خطورة بعض أشكال العنف الزوجي، بل وتبرّرها أحيانًا باسم العلاقة الزوجية.
كما تبقى مسألة عبء الإثبات إشكالية.
فإثبات وقوع عنف يكون صعبًا للغاية عندما لا يوجد شهود أو آثار جسدية واضحة.
إن هذا الواقع يخلق حالة من انعدام الأمن القانوني للضحايا.
وبالتالي، تتردد الكثيرات في تقديم الشكاوى، لأنهن لا يعرفن ما ينتظرهن.
وباختصار، تختلف كيفية التعامل مع القضايا بشكل كبير بحسب مكان تقديم الشكوى.
وبذلك، لا تُطبَّق العدالة بشكل متساوٍ على كامل التراب الوطني.
فقد تحصل امرأة ضحية للعنف في تونس العاصمة على أمر حماية بسرعة، في حين قد تواجه أخرى في منطقة ريفية بطئًا شديدًا أو حتى رفضًا.
وباختصار، فإن بعض القوانين المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي إما غير محددة جيدًا، أو تُطبَّق بشكل سيئ.
النتيجة: تختلف التفسيرات باختلاف القضاة أو المناطق، ولا تحصل الضحايا على حماية عادلة على المستوى الوطني.
نقص في خدمات الاستقبال والمرافقة
صحيح أن هناك مبادرات قائمة.
فهناك مراكز استقبال وخطوط استماع وجمعيات تبذل عملًا ميدانيًا مهمًا.
غير أن التغطية الوطنية ما تزال غير كافية.
فالقدرات الاستيعابية محدودة، والتمويل هش، والفوارق الجغرافية واضحة.
وتُظهر افتتاحات حديثة لهياكل أساسية، مثل مركز أروى القيروانية في القيروان، الأهمية الواضحة لهذه الفضاءات.
لكن هذه الهياكل تبقى قليلة جدًا وتعتمد بشكل كبير على تمويل غير مستقر.
وتظل المشكلة الأساسية هي التمويل.
فحتى مع وجود النوايا الحسنة، غالبًا ما تتراجع الجهود بسبب نقص الموارد الدائمة.
ثغرات في المعطيات والوقاية والمتابعة
ترتكز أي سياسة عمومية فعالة على بيانات موثوقة ومنتظمة.
ويشمل ذلك تكرار العنف، الأماكن المعنية، خصائص الضحايا، وحالات العود.
غير أن الآليات الإحصائية وأنظمة جمع البيانات في تونس لا تعمل بعد بشكل كامل، ولا هي منسّقة على المستوى الوطني.
وهذا يحدّ من تقييم أثر السياسات العمومية ويُعقّد تحديد الأولويات.
تمنع كل هذه الثغرات القانون من بلوغ كامل إمكاناته.
فامتلاك نصوص قانونية حديثة من دون هياكل تنفيذ قوية، أو تكوين ملائم للعاملين الميدانيين، أو تمويل دائم، أو قبول اجتماعي، يشبه بناء منزل بلا أساسات.
والنتائج ملموسة وخطيرة.
ضحايا لا يجرؤن على تقديم شكاوى.
جناة يفلتون من العقاب.
وتستمر حلقات العنف جيلًا بعد جيل.
ما الذي ينبغي فعله؟
يجب اتخاذ تدابير ملموسة ومحددة، بدايةً، ضمن جهد مشترك بين الدولة التونسية والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، ليتم تنفيذها بسرعة.
وفي هذا السياق، من الضروري تعزيز التطبيق الفعلي للقانون 2017-58.
كما يجب تخصيص ميزانية واضحة لتكوين ونشر وحدات متخصصة تضمّ في أغلبها عناصر نسائية.
وبالتوازي، ينبغي تكوين العاملين الميدانيين بشكل مكثف.
ويُضاف إلى ذلك ضرورة وضع برامج إلزامية ودائمة تستهدف قوات الأمن والقضاة والإطار الصحي والمساعدين الاجتماعيين.
ويجب أن تركز هذه البرامج على استقبال الضحايا، وإجراء التحقيقات، والمتابعة الطبية والنفسية.
كما ينبغي مضاعفة هياكل الاستقبال وضمان استدامتها، وذلك عبر إنشاء وتمويل مراكز جهوية، وخطوط استماع متوفرة 24/7، وبرامج للإيواء والمرافقة الاقتصادية للضحايا.
ومن الأفضل إنشاء مرصد وطني مركزي لجمع بيانات مجهولة الهوية حول الشكاوى، والقرارات القضائية، وتدابير الحماية، والاحتياجات الفعلية.
وسيسهّل مثل هذا الهيكل تخصيص الموارد ومتابعة السياسات العمومية.
وأخيرًا، يظلّ التغيير الثقافي العميق ضروريًا.
ويجب أن يتمّ ذلك من خلال حملات توعية وطنية واسعة، بما في ذلك داخل المؤسسات التعليمية، لتفكيك المعايير الاجتماعية التي تساهم في وصم الضحايا.
تتمتع تونس بإطار قانوني حديث.
وهي قوّة لا بد من تحويلها إلى واقع اجتماعي.
فاللامبالاة لها ثمن مرتفع.
إذ تُبقي آلاف النساء في حالة من انعدام الأمن، وتبطئ التنمية البشرية والاقتصادية في البلاد.
الحلول معروفة ويبقى الأمر رهين الإرادة السياسية، والتمويل الموجَّه، وشراكة حقيقية ودائمة مع المجتمع المدني.